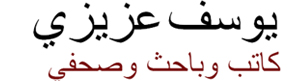يوسف عزيزي
السفير اللبنانية
11 شباط 2006
كانت ثورة الدستور (1906 – 1908) في ايران نتيجة لتحول اجتماعي شهدته البلاد منذ نشوء الدولة الصفوية التي وحّدت الامبراطورية الفارسية على اساس المذهب الشيعي تمايزا عن غريمتها الامبراطورية العثمانية ذات المذهب السني وذلك بعد أن شهدت الامبراطورية تفتتاً وتفرقاً بسبب هجمات المغول والتتار.
فثورة الدستور أو المشروطة لم تحقق أهدافها في بناء نظام ديموقراطي وإقامة ما يعرف بالامة الدولة التي كان الايرانيون يصبون اليها آنئذ. فقد حاول الشاه رضا بهلوي (1941 – 1925) أن يقوم بهذه المهمة في بلاد لا تضم الشعب الفارسي فحسب بل شعوب وقوميات أخرى كالاتراك الاذريين والاكراد والعرب والبلوش والتركمان.
وقد تحاشى الشاه رضا ومن ثم ابنه الشاه محمد رضا بهلوي (1978 – 1941) الاهداف الديموقراطية للثورة الدستورية وانتهجا نهجاً استبدادياً في ادارة البلاد.
وسعى الشاه رضا بهلوي الى ان يحول الامبراطورية الفارسية الى <<امة دولة>> ايرانية بواسطة قمع القوميات غير الفارسية؛ وكان شعاره والمنظرين التابعين له انشاء <<امة ايرانية ذات عرق واحد ولغة واحدة في دولة واحدة>>. فبرغم التطور الذي شهدته البلاد في مجال تدشين البنى التحتية لمجتمع متخلف اقتصادياً غير ان هدف الشاه رضا المنشود لم يتحقق بسبب اهماله للتنمية السياسية وتأكيده فقط على بعض وجوه التنمية الاقتصادية التي تتحكم بها الشرائح العليا في السلطة وليس الشعب نفسه.
وشهدت القوميات غير الفارسية صحوة قومية عقب سقوط الشاه رضا البهلوي مهّدت لها الحرب العالمية الثانية وتداعياتها الناجمة عن انتصار الحلفاء ووجود الجيش السوفياتي في شمال وغرب إيران.
وأدّت تلك الصحوة إلى قيام جمهوريتين يحكمان نفسيهما بحكم ذاتي هما: جمهورية آذربيجان (الايرانية) وجمهورية مهاباد الكردية. غير أن هذه التجربة باءت بالفشل لأسباب عدة لا مجال هنا للخوض فيها؛ وعاد البطش الشاهنشاهي أشد من السابق ضد الشعوب غير الفارسية التي تشكل اكثر من نصف سكان البلاد.
فالحركة الوطنية التي انتعشت في الاربعينات واوائل الخمسينات من القرن الماضي والتي توّجت بتأميم النفط الايراني لم تبدِ تعاطفاً مع طلبات القوميات غير الفارسية لنيل حقوقها ولو في إطار دستور ثورة المشروطة والذي كان يقضي بمنحها نوعاً من الحقوق المحدودة.
والسبب يعود إلى ايديولوجية زعماء الحركة الوطنية الايرانية (كمحمد مصدّق وحسين فاطمي وآخرين) حيث كانت تتغذى اساساً من الخطاب الفارسي.
وقد تمكّن الزعيم الراحل آية الله الخميني من توحيد القوميات المختلفة المستاءة كل الاستياء من النظام الملكي بشعار الثورة القائم على الاممية الاسلامية المتخطية للخطاب القومي الفارسي وذلك قبل قيامها في 11 شباط 1979. وقد تجلّى الأمر في المشاركة الواسعة للأتراك والعرب الشيعة بل والتركمان والأكراد السنة في تلك الثورة الشعبية العارمة.
فقد كان للتظاهرات التي قام بها الاذريون في 13 شباط عام 1978 دور هام في إضعاف نظام الشاه ومن ثم أطلق إضراب العمال العرب في منشآت النفط بالأهواز، رصاصة الرحمة التي قضت على حياة ذلك النظام.
فقد سدّدت الثورة الاسلامية ضربات موجعة الى الخطاب العنصري الشاهنشاهي المعادي للشعوب غير الفارسية لكنها لم تؤدِ الى محوه كاملاً. اذ ترسّخ هذا الخطاب الاستعلائي المتجسد خلال أكثر من نصف قرن في الكتب الدراسية والخطاب الادبي والتاريخي ترسخ في عقلية 3 أجيال متعاقبة من الايرانيين. كما سرعان وأخذ الخطاب الإيراني المنتصر أساساً بشعارات إسلامية أممية على النظام الملكي الشوفيني أخذ منحى قومياً اثر اشتداد الحرب مع العراق. وقد تفاعل هذا الخطاب مع النزعة القومية الفارسية المتلبسة بلباس ايراني في عهد الرئيس الاسبق هاشمي رفسنجاني. وبوصول الاصلاحيين الى السلطة في العام 1997 وتقلص دائرة تأثير الايديولوجية الاسلامية في الداخل، أخذ الخطاب القومي الفارسي يتغلغل بالتدريج في المؤسسات الإعلامية والسياسية الحكومية وغير الحكومية منها. غير أن الانفتاح التي شهدته ايران في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي منح القوميات غير الفارسية أيضاً الفرصة لتدشين خطابها على الساحتين السياسية والثقافية.
فثماني سنوات من العمل السياسي والثقافي والصحافي الحر نسبياً في عهد الإصلاحيين خلق صحوة عميقة وواسعة بين هذه القوميات نرى آثارها حالياً في مختلف المجالات وسيكون لها تأثيراً بالغاً في حياة الايرانيين مستقبلاً. أي إن قضية القوميات غير الفارسية ستكون إحدى أهم القضايا التي يجب البحث عن حلول سلمية لها وإلا ستكون لها آثار كارثية على مستقبل البلاد.
وبالرغم من احتواء الدستور الايراني على مواد تقضي بإعطاء القوميات بعض حقوقها لكن هذه المواد لم تطبق رغم مرور 27 عاماً على قيام الثورة. فهناك تطبيق ناقص للمادة 15 من الدستور التي تتحدّث عن ضرورة نشر الصحف بلغات القوميات غير الفارسية (التركية الاذرية والكردية والعربية والبلوشية والتركمانية) وكذلك تدريس لغاتهم وآدابهم في المدارس الابتدائية. وقد سمح الإصلاحيون لهذه القوميات بنشر بعض الصحف، لكنها لا تتناسب أساساً مع عدد الناطقين بهذه اللغات قياساً بالصحف الصادرة باللغة الفارسية. وخلافاً لنص الدستور الايراني لم يتمّ تدريس لغات هذه القوميات في المدارس الابتدائية رغم طلبها المستمر لذلك خلال العقدين الماضيين.
كما أن المادة 19 تنصّ على تكافؤ في الحقوق بين القوميات الايرانية <<دون أن يكون هناك اي امتياز لعرق محدد او لون محدد او لغة محددة>>. وتنص المادة 48 على الابتعاد عن التمييز في استغلال المصادر الطبيعية واستخدام الايرادات الوطنية وتوزيع الانشطة الاقتصادية على مستوى المحافظات.
وقد أدّى عدم تقيّد الحكومات المتعاقبة بتنفيذ هذه المواد الى مركزة حادة للشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية في العاصمة الإيرانية وإلى حرمان وتخلّف المحافظات خاصة تلك التي تقطنها قوميات غير فارسية.
وقد رأينا ردود فعل هذا القوميات في الاحداث التي شهدتها المناطق التي يسكنها العرب الأهوازيون والأكراد والأتراك قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها.
فقد شهدت محافظة خوزستان (الاهواز) تظاهرات واحتجاجات وتفجيرات وأعمال عنف منذ نيسان/ابريل، العام 2005.
وفي ديسمبر الماضي تمّ اغتيال أحد حراس الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وسائق سيارته أثناء زيارة الرئيس لمحافظة بلوشستان التي تقطنها أغلبية بلوشية. وتلى ذلك اختطاف 9 من العسكريين الايرانيين من قبل مجموعة اصولية سنية بلوشية في المحافظة الايرانية نفسها واغتيال أحد هؤلاء العسكريين والإفراج عن الباقين مقابل دفع فدية إلى المختطفين.
كما أن نسبة المشاركة بين الشعب الكردي في الانتخابات الرئاسية التي تمّت في يوليو 2005 كانت في أدنى مستوياتها بسبب المقاطعة الشعبية لتلك الانتخابات في المناطق الكردية في إيران؛ ولم يصوّت الاتراك الاذريون في المناطق التي يقطنونها كمحافظات اذربيجان الغربية واذربيجان الشرقية وزنجان واردبيل لأي من المرشحين الفرس الإصلاحيين والمحافظين كأحمدي نجاد وهاشمي رفسنجاني ومهدي كروبي ومصطفى معين بل ذهبت معظم أصواتهم لمرشح غير معروف من بني جلدتهم يُدعى مهر علي زادة؛ لأنه قام بتأييد الطلبات القومية للفصائل الاذرية، والتي كان لها صدى واسع في مناطقهم الواقعة في شمال غرب ايران.
الآن وفي ظل التوتر بين ايران والغرب أي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يبدو أن قضية القوميات غير الفارسية في ايران مرشحة للخروج من إطارها المحلي لتصبح عاملاً في معادلة الصراع الإقليمي والدولي.