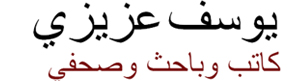يوسف عزيزي
يحتفل الإيرانيون هذه الأيام باليوبيل الفضي لقيام الثورة الإسلامية في11 فبراير 1979والتي تعتبر علامة فارقة في حياة الشعب الإيراني وفي تاريخ الثورات في العالم. وكانت تلك الثورة، ثاني ثورة يقوم بها الإيرانيون خلال قرن واحد حيث سبقتها ثورة الدستور”المشروطة” 1905-1908) ) وتعد الثورة الإسلامية، استثناء في قاعدة الثورات في العالم، حيث لم تحمل الثورات لا في فرنسا وروسية ولا في الجزائر وفيتنام أي سمات دينية بل بالعكس كانت جميعها ثورات علمانية. ويعلل بعض المحللين وقوع الثورة الإسلامية في إيران إلى تطبيق مشروع شبه حداثي للمجتمع الإيراني، تجلت فيه سمات المجتمع الجماهيري (مس سوسايتي) في السبعينيات من القرن المنصرم حيث شهد هذا المجتمع وبسبب ارتفاع أسعار النفط، عملية تنمية تعسفية وسريعة وغير متوازنة جدا لرأسمالية الهامش التي كانت سائدة في عهد الشاه. وقد أدت هذه العملية إلى تطورات اجتماعية واقتصادية هامة. فقد توسعت المدن التي أدت بدورها إلى انسلاخ الجماهير القروية من قراها وإضعاف العلاقات التقليدية القديمة. وولجت الجماهير الفقيرة والمتمردة المهاجرة من الريف إلى المدينة ولجت الساحة السياسية دون أي ثقافة ديمقراطية أو مشاركة سياسية. فلا المؤسسات الحكومية الرسمية في عهد الشاه كانت قادرة على استقطابها – وهي لم تتمكن من استقطاب الشرائح الاجتماعية الحديثة – ولا امكانات الأحزاب والمنظمات الحديثة والمعارضة للحكم الملكي كانت تسمح لها بالارتباط مع الجماهير المستاءة وتنظيمها. وقد تعرضت هذه الأحزاب لقمع وتنكيل نظام الشاه ومؤسسته الأمنية الرهيبة (السافاك). واستطاع الخطاب الإسلام السياسي أن يستقطب هذه الجماهير المليونية المترددة والمنفصلة عن العلاقات والهويات الجماعية التحديثية كالأحزاب والنقابات والمنتديات وان يقودها إلى التمرد على الوضع القائم آنذاك. إن ضعف المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة أدى أيضا بالشرائح الاجتماعية الحديثة كالطبقة الوسطى وطلبة الجامعات والبرجوازية المحلية ـ التي من المفروض أن تنتمي إلى خطابات سياسية متباينة – أدى بها أن تقبل الخطاب السائد عشية الثورة وهو الخطاب الثوري الشعبوي الإسلامي المعادي للإمبريالية. وتأتي معاداة الثورة الإسلامية للإمبريالية الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تدخلها في شؤون إيران الداخلية وخاصة الدور الأمريكي في الإطاحة بالحكومة الوطنية التي كان يترأسها الزعيم الوطني الراحل محمد مصدق في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. وقد شغلت الثورة الإيرانية بعظمتها وشعبيتها بال العديد من الأدباء والمفكرين حيث انشد الشاعر العربي المعاصر ادونيس في عام1979 قصيدة أشاد فيها بالثورة وقائدها آية الله الخميني واعتبرها ردا على غطرسة الغرب وطريقا جديدا في حياة الشرق والمسلمين. كما انبهر بها الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو وزار إيران في تلك السنة لغرض الفضول والاستطلاع وصنّفها ضمن ثورات ما بعد الحداثة ؛ لكنه غير رأيه فيما بعد وكتب رسالة إلى مهدي بازرغان أول رئيس وزراء عقب قيام الثورة، أعلن فيها عن خيبة أمله لما تتجه إليه الثورة من مسار وذلك بسبب ما وصفه باستئثار رجال الدين للحكم وابتعاد الثورة عن المسار الديمقراطي. وهذا ما حدث لادونيس أيضا حيث سحب تأييده للثورة الإيرانية واخذ ينقد مسارها السياسي. غير أن الثورة الإيرانية ورغم كل ما قيل ويقال عنها – وهو الكثير- تبقى ثورة هامة غيرت مجرى التاريخ الإيراني وأيقظت صحوة إسلامية في المنطقة والعالم وأطاحت بأعتى الأنظمة الدكتاتورية في العالم وكانت نهاية لـ25 قرنا من الحكم الاستبدادي للأباطرة والشاهات في إيران. ويبدو أن كل ما يعاني منه الإيرانيون من تضييق على الحريات الديمقراطية والاتجاهات الشمولية لدى بعض رجال الدين هو ناجم عن ارث شاهنشاهي استبدادي ثقيل يحتاج التخلص منه إلى مرور الوقت؛ ولذا نتمكن أن نصف الفترة الحالية في إيران بالمرحلة الانتقالية من الاستبداد إلى الديمقراطية. ويدعى بعض المحللين ان مبدأ “ولاية الفقيه” أو كما يصفها الدستور المعدل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 1989 ب”الولاية المطلقة للفقيه” هو استمرار لتقليد إيراني للمركزة السياسية والاجتماعية. مع الفارق أن الثورة قامت بتهديم الحكم الفردي الملكي المنسجم مع نفسه وأوجدت نوعاً من الشرخ في الحكم والتعدد في مؤسسات السلطة غير أن هذه المؤسسات لم تصل حد الاستقلالية والتأثير الذي نراه في الدول الديمقراطية وهي محكومة بسلطة رأس الهرم. والشرخ هذا موجود منذ ولادة الثورة الإيرانية حيث كان يضعف ويشتد وفقا للظروف السياسية والاجتماعية، وان ما نراه من ازدواجية في الحكم منذ انتخاب محمد خاتمي كرئيس للجمهورية قبل 7 سنوات وحتى الآن يعود إلى هذا الأمر. وما يبذله المحافظون من جهود هذه الأيام للهيمنة على البرلمان ومن ثم الحكومة يهدف إلى توحيد مؤسسات الحكم، غير أن هذا لن يحصل بصورة كاملة كما كان في عهد الشاه بسبب طبيعة الدستور الإيراني والتناقضات القائمة في نصه. فأهم تناقض سياسي هو بين المؤسسات المنتخبة بأصوات الشعب مباشرة من جهة كرئاسة الجمهورية والبرلمان والمجالس البلدية والمؤسسات غير المنتخبة كمجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام. وتبقى مؤسسة ولاية الفقيه بين الاثنين لأن ولي الفقيه منتخب لفترة غير محددة من قبل مجلس خبراء القيادة وهذا المجلس هو بدوره أيضا منتخب من قبل الناس،غير أن جميع أعضائه هم من رجال الدين فقط وان مجلس صيانة الدستور ـ المعين أعضاؤه من قبل المرشد- هو الذي يزكي تأهيل المرشحين لهذا المجلس. وأما الاقتصاد الإيراني، خليط من مؤسسات تابعة للقطاع العام وهو قطاع واسع (نحو80 في المائة) والقطاع الخاص وهو قطاع صغير نسبيا ( 20في المائة تقريبا). لكن نفس القطاع العام أيضا ينقسم إلى قطاع تابع للحكومة التي يرأسها حاليا محمد خاتمي (نحو 40في المائة من القطاع العام) وقطاع تابع لمؤسسة ولاية الفقيه ( نحو60 في المائة من القطاع العام) ويشمل القطاع الأخير، مؤسسات عملاقة كمؤسسة المستضعفين التي تملك جميع الشركات المصادرة والتابعة سابقا للشاه وحاشيته والبلاط الملكي المنهار وكذلك مؤسسة “إمداد الإمام” التي تملك العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية. ويعفي الدستور الإيراني هذه المؤسسات الاقتصادية من دفع الضرائب للحكومة التي ليس لها أي إشراف على إدارتها. وقد جاءت الحركة الإصلاحية في أواسط التسعينيات من القرن الماضي لحل الأزمات السياسية والاقتصادية التي أخذت تعصف بالمجتمع الإيراني عقب انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية (1988-1980). وقد تواصلت عملية اتساع المدن على حساب القرى في إيران بعد الثورة حيث ارتفعت في الفترة 1977- 2001 نسبة سكان المدن من 47% إلى 66% وبلغ عدد المدن في نفس الفترة من373 الى700 مدينة. وارتفع عدد المدن التي تحوي أكثر من 25 ألف نسمة من 16 إلى 23 مدينة خلال الفترة 1986 – 1996 ، حيث يعيش نحو ثلث سكان البلاد حاليا في 5مدن كبرى. كما ارتفعت نسبة الشباب ( 15-24 سنة) من 18.9% إلى 24.5% من عدد سكان البلاد أي مايعادل10 ملايين نسمة. وارتفع عدد الطلبة الجامعيين في إيران من175 ألفا في عام الثورة إلى نحو مليوني طالب حاليا، ناهيك عن ازدياد عدد الجامعات